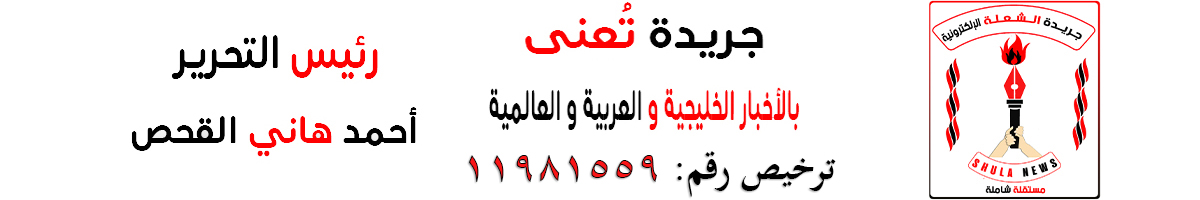«الرغبة» لريتشارد فلاناغان.. هزيمة «المتحضر» الغربي

على موقع تويتر طرحت إحدى المستخدمات سؤالاً: لماذا انفصل الأدب عن نظرية المعرفة؟ هذا السؤال، بصيغته تلك، لا يكرر مشكلة علاقة الأدب بالحقيقة: «هل يقول الأدب الحقيقة؟»، بل يمتد إلى أهمية الصيغ الأدبية نفسها كأدوات للمعرفة، وهذا يتوقف بالتالي على ما يمكن أن نعنيه بالمعرفة أو الحقيقة.
في رواية «الرغبة»، للأسترالي ريتشارد فلاناغان، الحائز جائزة مان بوكر عن رواية «الطريق الضيق إلى أقصى الشمال»، لا يُطرح سؤال كهذا مباشرة، ولكن من خلال سرد يتداخل فيه الواقعي بالخيالي، أو بالأحرى يتبادلان الأدوار، بحثاً عن مفهوم مختلف للحقيقة.
تتناول الرواية قسماً من الحقبة الاستعمارية للإمبراطورية البريطانية، التي امتدت اكتشافاتها إلى الشمال القطبي. إنه العصر نفسه الذي عاش فيه الروائي الإنكليزي الأكثر شهرة تشارلز ديكنز. تدور أحداث الرواية على مسارين متوازيين، لكن غير منفصل أحدهما عن الآخر. المسار الأول يتمثل في مشروع أحد المستكشفين الإنكليز وزوجته، اللذين أرادا إقامة مستعمرة «نموذجية» لترويض المتوحشين، كما ينظر إليهم من قبل المستعمرين. لكن شيئاً ما يحدث لإحدى حملات هذا المستكشف. فالحملة التي حاصرتها الثلوج وقضى من فيها ونظر إليهم حينها كأبطال، يستعيدها مقال في صحيفة وفق شهادة معاصرة لها ملمحاً إلى أن أفراد الحملة قد تحولوا إلى متوحشين. لقد كانت نهايتهم بالتحديد سقوطا للحضارة، وتحولا إلى أكلة لحوم بشر، نهاية غير مشرفة بالبطع لراغبي الأمجاد الحضارية. هذا ما تشعر به زوجة المستكشف، التي تلجأ بدورها إلى تشارلز ديكنز، ليكتب مقالا مدافعا عن حملة الزوج الراحل، ومفندا مزاعم المقال الذي كتبه طبيب لا يمتلك قوة أسلوب وحجة الكاتب العظيم.
حياة الكاتب
المحور الثاني هو حياة تشارلز ديكنز نفسه، لكن بالأحرى هي قصة الكاتب أو الفنان في مجتمع يفصل بين الرغبة والعقلانية، مجتمع يعتمد تصوره العقلاني على قتل الشعور الفردي والضبط القسري للتعبير الحر، كما يفصل في الآن نفسه بين ما يسميه الحضارة، وما يعتبره توحشاً.
ليس الجمع بين هذين المحورين مجرد تخييل أدبي، بل هو يضعنا أمام مهمة الخلق الأدبي نفسه: أين هي الحدود التي تفصل بين الواقع والخيال؟ بل هل ثمة حدود أصلا؟ وفي المقابل ما هي الحدود بين الرغبة والعقل؟ وإلى أي مدى يفضي الفصل بينهما إلى ما يشبه التدمير الذاتي والتوحش.
في الرواية تبدو معاناة تشارلز ديكنز مع الأدب، وكأنه تعويض عن حياة مخفقة. الروح النشطة لديكنز الروائي والمسرحي يقابلها أداء متحفظ في الحياة «الواقعية». لكأن أحد الجانبين عليه أن يحترق من أجل الآخر.. «كان يبدو أن المزيد من ذاته في كتبه يعني القليل منه في الحياة.. فقط في عمله كان ديكنز يشعر أنه يجسد نفسه حقاً، فقط عندما كان يرتدي قناع هذه الشخصية أو تلك، فإنه كان يكتشف الحقيقة الجلية عمن يكونه، كانت رواياته حقيقية بطريقة لم تكنها الحياة».
وجهان للكائن المتحضر
كما أن لندن حاضرة ومرصودة غالباً بعيني ديكنز (الروائي والشخصية الروائية في الوقت نفسه)، فإن صورة المستعمرة الخاضعة لحكم الغرب المتحضر حاضرة أيضاً من خلال شخصية محورية أخرى هي «ليدا»، أو «ماثينا» كما يقال لها، ابنة أحد السكان الأصليين.
تجسد «ليدا» أو «ماثينا» فشل مزاعم التحضر التي قامت أساساً على الفصل بين روح الإنسان وعقله، بين البيئة المصطنعة التي أنتجها الإنسان والطبيعة، بين الحلم والواقع، بين الحياة كما نعيشها وبين سرد هذه الحياة نفسها.
يتبنى الزوجان جون وجين الطفلة المتوحشة، يعتقدان في الدور الحضاري العظيم الذي سيقومان به، لكي تصبح الطفلة البداية نجمة الصالونات الارستقراطية، مقتنعين بإمكان تخليص روحها من الأساطير، وجسدها من الهمجية.
«ليدا» هي النقيض من الصنعة البرجوازية، ومن الطموح إلى النجاح الذي يقتضي التحفظ والرياء؛ قدم تحنّ إلى التراب، عصية على الأحذية المحبوكة، عقل ذكي، لكن يرفض التعلم الذي يفصل بين الكتابة والروح. تتعلم ليدا الرقص، لكنها في حفل عام تدهش الحضور بخروجها عن النظام، تمردها على الخطوات المحفوظة سلفا، لتندمج في رقصة «همجية» تترك لأعضائها حرية مرعبة، وتنتهي بإغماءة كإغماءات الوجد.
«المستعمرة»، أيضا كما تصفها الرواية، كيان لا يقل تشوهاً عن المدينة الضبابية التي يفرط فلاناغان في وصف بيوت فقرائها الحقيرة وحاناتها، وليلها البارد الذي يعبره دخان كئيب.
أكثر من سرد أدبي
لكن الرواية تضعنا أمام إشكال آخر: أهؤلاء هم السكان الأصليون حقاً، أم ما يريد تصويره ريتشارد فلاناغان؟ إن التناقض الحاد بين شخصية «البدائي» والمستعمر المتحضر، حتى وإن كانت تدين الأخير فإنها تعزز الفصل الذي تسعى إلى تجاوزه بالذات، وتؤكد الصراع مرة أخرى بين العقل والرغبة منحازة للأخيرة. نحن لا نكاد نسمع صوت ليدا نفسها، نراها هنا ترقص أو تتمرد أو تغوي أو تلعب. شخصية لا إشكالية إلا بقدر ما يفسدها التدخل من الخارج، وكأننا أمام صورة لعالم وادع متسق مع ذاته ومكتف بها لا يعكر صفوه إلا الغرباء.
مع هذا تبدو الرواية في هذا التوقيت بالذات، وكأنها أكثر من سرد أدبي، حيث تتبنى ما يشبه المراجعة الجذرية لمعنى التحضر الأوروبي الاستعماري، وكيف أن ما باعه الغربي في موطنه من أجل الصعود والسيطرة و«المجد»، هو نفسه ما يشكل هزيمته في الخارج، وفشله في فهم الآخر: لقد خسر الرغبة، ومعها خسر الذات والآخر معاً.
الرواية من إصدرات دار الجمل لعام 2018، بترجمة حنان المسعودي.